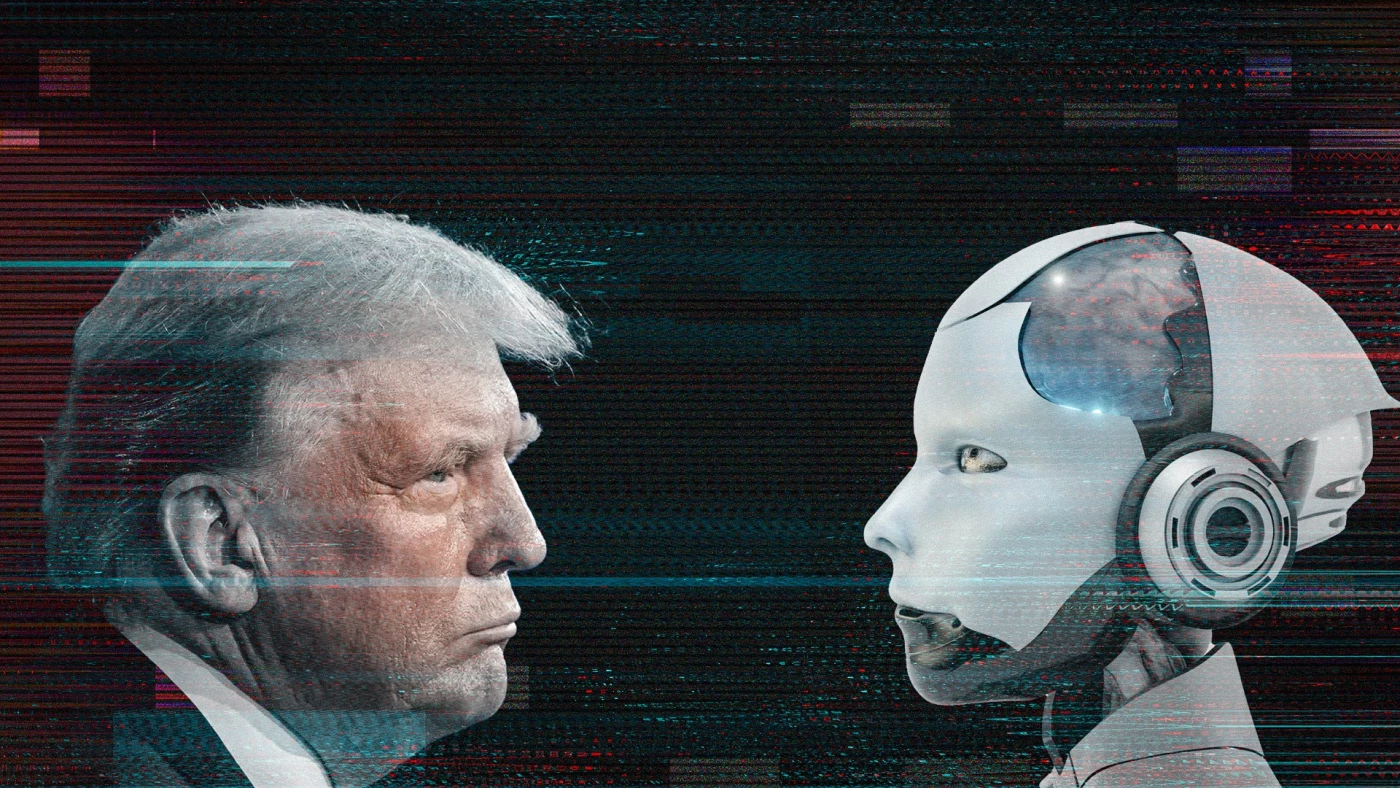العلم والدين عالمان مختلفان

الغرض من هذه الكتابة هو إيضاح الحاجة للفصل بين الدين والعلم، في الوظيفة والقيمة ومناهج البحث، لا سيَّما أدوات النقد.
لا نريد مجادلة القائلين بأنَّ العلم جزء من الدين، أو أنَّ الدين قائم على العلم، فهذه تنتهي غالباً إلى مساجلات لفظية قليلة القيمة، تشبه مثلاً إصرار بعضهم على أن قوله تعالى «وعلّم آدم الأسماء كلها» دليل على أن العلم والدين كليهما يرجعان لمصدر واحد، لهذا فهما متصلان. هذا النوع من الجدل لا ثمر فيه ولا جدوى وراءه.
- ربما يقول قائل: فلنفترض - جدلاً - أنَّنا قبلنا بهذا التمهيد، فما جدوى هذه النقاشات التي أكل عليها الدهر وشرب؟
جواباً عن هذا، أقول إن غرض النقاش هو التشديد على استبعاد المؤثرات العاطفية، عند النظر في هذه المسألة وأمثالها. وهي مؤثرات مُحرّكها - فيما أظن - ارتياب في الأفكار الجديدة، لا سيما إذا لامست قضايا مستقرة لأمد طويل. واقع الحال يخبرنا أن الإصرار على ربط العلم بالدين أدى إلى إقصاء المنطق العلمي الضروري لمواجهة المشكلات. فكأن العقل الكسول يقول لنفسه: ما دمنا نستطيع تحويل المشكلة على الغيب، والخروج بحل مريح، فلماذا نجهد أنفسنا بحثاً عن حلول غير مضمونة؟ ولعل بعضنا يتذكر الواعظ، الذي هاجم الداعين لإغلاق الجوامع والمشاهد التي يزدحم فيها الناس أيام وباء «كورونا»، وقال ما معناه: إن العلاج الحاسم للوباء يكمن في التوسل إلى الله والاستشفاع بأوليائه كي يُنعم على المرضى بالشفاء. وهذا غير ممكن إلا بترك أماكن العبادة مفتوحة للمصلّين والداعين، أما المرض فهو موجود في أماكن الإثم وليس في أماكن العبادة، المرض لا يأتي إلى محل التشافي منه!
ومن ذلك أيضاً التوافق القائم منذ قرون، على أن «علم الدين» ينبغي ألا يتجاوز الحدود التي رسمها العلماء الماضون، لهذا اقتصرت بحوث المعاصرين على شرح أقوال السابقين، أو تحقيقها، أو التعديل عليها قليلاً، ونادراً ما تصل لنقضها أو اقتراح بدائل تُعارضها جوهرياً. بمعنى آخر، فإن «علم الدين» المعاصر ليس أكثر من تأكيد لأخيه القديم.
ونظراً لشيوع هذا المفهوم وتلبُّسه صبغة الدين، فقد تمدَّد في غالبية نظم التعليم والبحث العلمي العربية، لهذا ترى العلم القديم حاضراً بقوة في معظم الأبحاث، لا كموضوع للنقد والمجادلة، بل كأساس يقف عليه الباحث أو دليل يرجع إليه، مع أن القاعدة العقلانية تفترض أن العلم الجديد أكملُ من سابقه.
العلم والدين عالمان مختلفان في الوظيفة، فالعلم غرضه نقض السائد والموروث، واستبدال ما هو أحسن به، ولذا فإن معظمه يركز على مساءلة الأدلة والتطبيقات، والعمل على نقضها والبحث عن بدائلها، أما الدين فوظيفته معاكسة، يوفر الدين اليقين؛ أي الرؤية الكونية التي تجيب على أسئلة الإنسان الوجودية، فتولد الاطمئنان إلى المصير. كما توفر الشريعة الأرضية الفلسفية للقانون، والمضمون المناسب لقواعد العمل الفردي والجمعي في المجتمع الإنساني. ونعلم أن تواصل الإنسان مع الكون الذي يعيش فيه ليس من نوع الآراء التي يمكن تغييرها بين حين وآخر. كذلك فإن الاستمرارية جزء من طبيعة القانون، حتى لو قلنا بإمكانية تغييره وتحديثه.
نظراً لاختلاف الوظيفة، فإن منهج البحث في الدين مختلف عن نظيره في العلم. وهنا لا بد من التذكير بضرورة التمييز بين الدين والمعرفة الدينية، حيث يراعى في الدين مصدره الإلهي، بينما المعرفة الدينية بشرية وغير معصومة، فهي تخضع لنفس قواعد وأدوات النقد المتعارفة في العلوم العادية.